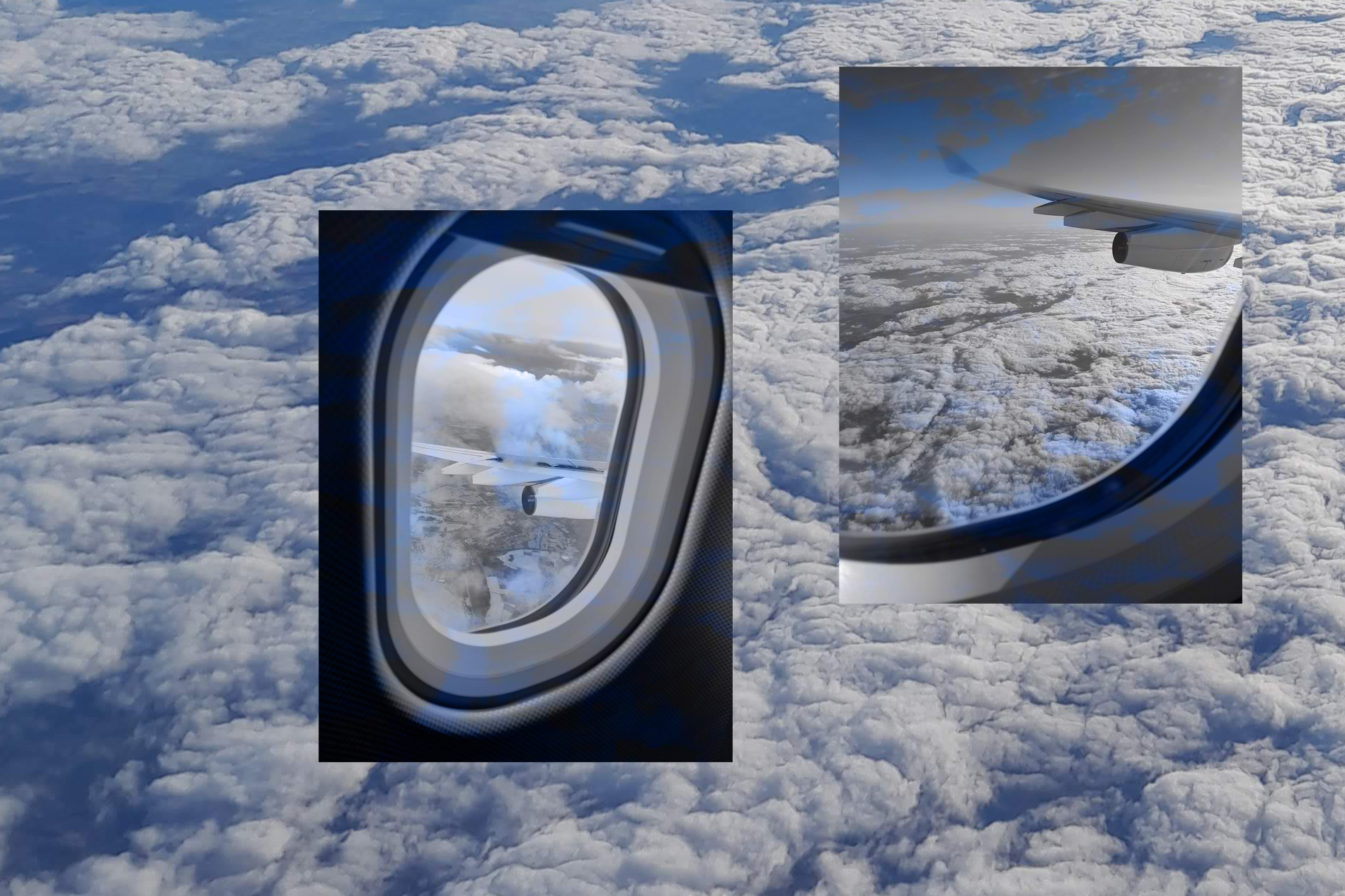
العزيزة لينة،
مسّتنى رسالتك الأخيرة،كما مسّت الحضور فى قاعة القراءة، فعادوا يسألون عن خُبزك وشِعرك، وبما أنك طرحت عددا من الأسئلة فلك أيضًا بعضها.
متى تدخلين المدن يا لينة؟ أنا أدخل المدن الغريبة فى الليل.
هل يحدد الوقت الذي ندخل فيه المدن علاقتنا بها؟ هل ترقد هذه اللحظات فى ذاكرتنا مثل ليترات البنزين غير المستخدمة فى قاع التانك؟ وجودها ضروري ولكن دون نفع مباشر! ذاكرة غير مستعملة. بمجرد الوصول إليها يعنى تلف متوقع لمحرك السيار الليترات الراكدات، أثقل من غيرها، سلة للشوائب على مدار شهور وربما سنوات.
فى بداية علاقتي بالسفر، وجدتني أميل إى اللحاق برؤية السحب فى مواضعها المختلفة، لحظة الدنو ثم الاختراق، والدخول فى كبدها ثم الخروج نهائيا واستقرار الطائرة فوقها، نكشف الشمس العارية المتجولة، لهيبها تواق، حرارتها غير محسوسة، أما السحب تظل سجادة مفتوحة للصلاة، بساط أبيض أو رمادي متطاحن ومتداخل فى لحظة الاشتباك القصوى، لحظة انهيار المسافات. نرمي نظرنا لأسفل، نجد عجينة القطن الأبيض، ممضوغة وملقاة أسفل صاج حديدي طائر، ما أبسط الحقيقة عندما نراها من علو.
سألت الرفاق فى المنافي ، متى دخلوا بلادهم الجديدة، جاءت أغلب الإجابات، فى الليل، فى الشتاء، في الفراغ والضباب، أغلبهم قابل وجوه المدن المذعورة، الأرصفة المبتلة دائما، لا صوت للخطوة، فقط أصوات جر الشنط الثقيلة على الأرض، وأصوات النداء الإلكتروني لمحطات قطار خالية، تدوي فى فراغات محكمة، تعلن اقتراب الوصول أو الرحيل، وتحذر المسافرين عدم نسيان حقائبهم، لكن حقائب الغريب هى حياته، فلن ينساها أبدا. منذ عشرة سنوات أو أكثر كنت أرى دخول المدن ليلاً، رومانسياً وحالماً، فالمدن تتنفس الليل، لكنه لم يعد كذلك! تراكمت طبقات الذاكرة والخبرات، وتعلمت أنني إن دخلت البلاد الغريبة فى الليل الثقيل، فهذا ثمن مقابلة الشمس فى السماء.
***
ركضت كثيرا للوصول إلى قاعة الانتظار، قرب بوابة دخول الطائرة، الزجاج يفصلنا عن جسمها الضخم، الحرارة تحت الصفر والضباب يقضم نصف الأشكال فى الخارج، طائرة بدون ذيل، نصف علامة ضوئية بلا معنى، عمود كهرباء يصعد للسماء بلا نهاية، وحرارة جسدى لا تزال مرتفعة من اللهاث، فتحت الهاتف وأكدت للاصدقاء لحاقي بطائرة العودة الى مصر، وقفت فى طابور العائدين.
طالعت الخبر، موت الفراشة إثر اقترابها من الضوء الشديد! قبل أن تعود يومًا إلى حيث عاشت وأحبت وصادقت واختارت. الموت ظهر الآن كبديل للعود خيار مكتمل. انسحاب حاسم من الصراع. انفعالات وتعابير غير مجربة، غير مستعملة بجدية، سوف تحترق الفراشة أمامنا جميعا بينما المشاهدين مشغولون بمراقبة السياق والظرف التاريخي واللحظة السياسية!
نظرت حولي، فى طابور الدخول للطائرة، لم أجد وجها أعرفه أبلغه الخبر المفجع: لقد مات محمد أبو الغيط، الصحفى الشاب المطرود من بلاده مثل آلآف، الذى انجز عدد من التحقيقات الصحفية الفارقة واستهل مشروعه فى الكتابة بالنص البديع عن فقراء وضعفاء الثورة حينما كانت فى عنفوانها وموجتها الكبيرة.
مات أبو الغيط فى المنفى، قبل الوصول إلى لحظة مثل هذه، لحظة عودة طبيعية ومستحقة، يتعاظم الوقت ليصير بحرًا من الرمال لا يمكن حمله أو نطره بعيدًا، لا يمكن الغوص فيه ولا يصلح معه العوم، سنحمل اللحظات المخيفة معنا إلى حيث نعود، حنين يتحول إلى كابوس، وكابوس يتحول تدريجيا إلى حنين، وطرقا يغمرها الصدأ و“كم عذبني طول الرجاء“ كما صدحت الست فى ليل لا يعرفها ولا تعرفه، ليل البعيدين.
الطابور طويل، يتحرك ببطء. اكتشفت بعد قليل أنه لا يتحرك أصلا! البوابة لم تفتح بعد! ينتظر نظام الملاحة الجوية، انقشاع الضباب بنسبة معينة حتى يعطي للطائرات إشارة الإقلاع. وقفنا فى انتظار ارتفاع الضباب عن الأرض، السماء لا يمكنها حمله، يكفي صدورنا حمله!
تركت الطابور وبحثت عن مكان يصلح لصب الدموع السريعة المداهمة، اقتحمتني اللحظة، رأيت كل الوقائع الآن تحت عدسة مكبرة، لا يمكن تفويتها أو تجاهلها أو حتى التعامل معها بحكمة، الحكمة استعارة، والاستعارة فرار من المعنى المباشر، والفرار من الجحيم حق، ولكن ملاقاة الشمس حق.
قال لى صديق فى لحظة وداع دقيقة على سرير مستشفى في العاصمة الفرنسية، لو لم أمرض لكنت إلى جوارك فى البلاد، لم أقرر تركها رغم أهوالها، رددت برأسي أولا كثيرا وقلت فى النهاية : أعرف. سقطت هذه الجملة من ذاكراتي لحظة قولها، كأنني بلعتها كاملة دون مضغ أو هضم، وفجاة تذكرتها على باب الطائرة أيضا، فجأة تحولت فوهة الطائرة ألى عدسة مكبرة لكل أحداث هذه الرحلة. تركك العمر كله يا صديق ولم تتركه وغبت عن البلاد للعلاج التى يرحل منها الأطباء قبل المرضى للفقر وضيق الحال كما نفي أغلب محبيها وموهوبيها، الذين كلما نقصوا واحدا، نقصت حياتنا جمالا، تعاظمت حيل الديكتاتورية لحصارنا، تكاتف ضباعها مثل بنيان مرصوص لا يمكن تجاوزه ألا بالنهش والترويع.
كيف أحدثكم عن تداعيات غيابكم الكبير عن حياتنا، البلاد هي نحن وأنتم، بلادنا هي كلامكم وضحكاتكم وأرائكم، منذ 11 عاما ونحن نمشي داخل فجوة زمنية اعتقدنا جميعا أن لها نهاية نراها، لا نهاية واضحة أمامنا، الحقيقة، أن السحابة الوحيدة لا تمطر، كلما غاب سطر، خاب المعنى، تموت كل النصوص تباعا.
كانت كلمات صديقي على سرير المرض، أظافر تنبش عقلي، تنقر فى مكامن الأعصاب، كان يحب المجاز واللعب بالكلمات، كلماته الآن واضحة وصريحة وعارية حتى من المشاعر، تحررت من العاطفة القشرية، هناك عاطفة أقوى وأكثر شراسة من كلمات الحياة المعاشة اليومية التي نبذل الجهد فى اختيار ما يناسبها وما يناسب السميعة، لكن المسافات تقصر عند المرض، تتحول إلى نقطة يذهب إليها السهم مباشرة.
فتحوا فوهة الطائرة وتسرب الركاب، حشرت نفسي بينهم، جموع لا تعرف بعضها يلتقين فى الهواء، يعصرن ذواتهم وأشيائهم لتناسب الحمولة المتاحة، كنت لازلت أبحث عن مكان لصب الدموع، الطابور يتدحرج إلى الداخل، الزجاج حولي من كل مكان، شفاف بما يكفى للشعور للبرد، لا ركنة متاحة للاتكاء أو الاختباء لثوان، جميعنا مكشوفون، تتدلى من أقدامنا خطوة مكررة، حتى وصلنا، وكالعادة مقعدى فى ذيل الطائرة، سأمشي أطالع وجوه كل الراكبين ويطالعون وجهى قسرا، يعاين بعضنا بعض، وصلت إلى مقعدى بجوار النافذة.
استقريت فى المكان المحدد والذى تحول إلى المستقر الإجباري لصب الدموع، لا فرار، يتبقى اختيار اللحظة المناسبة، بدت لى لحظة الإقلاع مناسبة.
لحظة الإقلاع مناسبة لعدة أسباب علمية بحتة، الجالسون بجوار شباك الطائرة، يتحولون إلى مراقبين للتحولات السريعة فى طبقات الجو التى تخترقها الطائرة، واحدة تلو الاخرى. يمكنني أن أنتظر، لحظات صدمة بخار الماء بجسم بارد.
فوق زجاج الشباك، يمكننا أن نرى انشقاق الهواء إلى قطرات من الماء، تتسارع وتركض فى اتجاه عكس الطائرة، عكس اتجاه الهواء، فى تضاد واضح مع حركة الجسم الكبير الذي يحملها. فى هذه اللحظة ربما يمكننى محاكاة الطبيعة.
لحظة انتشال الطائرة مخالبها من الأرض، هي اللحظة القصوى لانخلاع القلب، بعدها يتعود إلى التموضع في مكانه الأصلي بمجرد أن تستقر فى غلافها المسموح، لكن الانخلاع الحقيقي للقلب يأتي من الفشل المستمر فى اللحاق بكل الفرص الممكنة، أو محاصرة المحاولات في تعبير أدق، كان لدى فرص أسهل لصب الدموع فى مدينة منذ أن وصلت إليها، تنفتح عيوني من تلقاء نفسها، تدمع من هول انخفاض الحرارة، كان من السهل تمرير دموعى بين طوفان بكاء الجوى كما أطلقت عليه، لكن العدسة المُكبّرة لا يفوتها أوقات مثل هذه. جاء خبر رحيل أبو الغيط على مقربة من فوهة العودة. لو كان بيدى لأهديتك كل خطواتي لتعود! أهدى خطوة لكل قدم شريدة. حطمت الديكتاتورية الحالية مرثية : عاد البلاد فى كفن. حتى الأكفان لا يريدونها أن تعود. يخافون موتانا بعد هلاكهم منفيين، يا للضعف المستتر بالبطش!
***
يا لينة، أريدك أن تعرفى فى نهاية رسالتى حقيقة واحدة، أنني أتوق مشاهدة السحب رغم الإحباط الواقع فى كل مرة، أراقب غرورها، زيفها، حيث تخترقها الطائرة، نشاهد بخار مياه بجوار النافذة، البخار العدمي، الهش، اللاجدوى المضيئة، يمكن نفضها سريعا بحرارة مفاجئة، إن موضع السحب فوقنا، يعطيه البهاء المحكم، اليد العليا، السيطرة العالقة، لكن الاقتراب منه هذه السحب، ملامستها للصاج الذي يحملني، رؤية الجزيئات تتأرجح وتتلاشى وتحل أخرى مكانها فى ثوان، تأريخ سريع لمعنى حركة الزمن، وحركة الكائنات الهشة التي نحبها.
يا لينة، هل هناك حلول واقعية لمجابهة اللوعة؟ لحظة الكى البطيئة لقرحة مفتوحة تسرح فيها السوائل الحية؟
يا شتاتنا..ننتظركم على أقدامكم، ما دامت فى القلب لوعة.
حطت الطائرة، واستبعدت فكرة البكاء كليا.
وصلت القاهرة فى غروبها.
رشا عزب




