راشيل خارج السرب
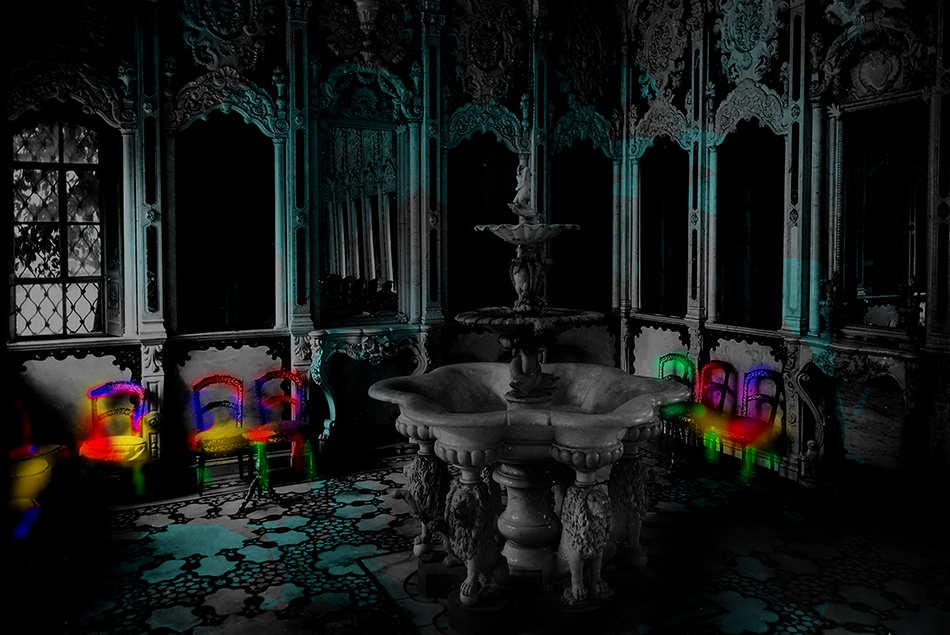
لم تُعجب راشيل في يوم من الأيام، بطريقة حياة شقيقاتها الثلاث: “ فردوس ومارسيل وأستير“ اللواتي قضين زهرة شبابهن اليانع، في العمل لساعات طويلة في مشغل خياطة مقابل قصر شمعايا. يلُكن الدقائق والساعات والأيام والأسابيع والسنوات برتابة بطيئة، قاتلة، وهنّ يحلمن بجمع „دوطة“ العريس المنتظر من أبناء الطائفة، في الوقت الذي راح فيه شبابها يتسربون الواحد تلو الآخر، بطرق غير شرعية. يختفون تحت ستار من السرّية الحديدية، دون أن يعلم أحدٌ: متى وكيف؟!
انسحب هذا الأمرُ على أشقائهن الشبّان الثلاثة، الذين اختفوا على نحو غامض، مخلّفين وراءهم صمت القبور، في بيت يئن برغبات العوانس…العذارى…الحالمات.
سلّم والدهن العجوز „رفول“ الروح بعد فترة قصيرة على هجرة أولاده غير الشرعية. ثمّ لحقت به زوجته التي ألمّ بها حزنٌ كامدٌ على تشتّت أسرتها، وإحساسها العميق بوحدة بناتها، وعزلتهن المخيفة، دون أمل أو رجاء…
وحدها راشيل كانت من طينة مختلفة عن شقيقاتها، بل هي مختلفة عن معظم الصبايا اليهوديات في الحارة. ربما لأنها أكثر واقعية منهن. تعيش اللحظة، بلا أوهام زائفة…أو سراب واهم . كانت فتاةٌ فاتنة، مشتعلةٌ.. صاخبة. تصغي باهتمام إلى نداء روحها، وجسدها الفائر بالرغبات. لا تنتظر، ولا تهرب إلى الأمام، ولا تحلم أحلاماً رومانسية تعرف مسبقاً أنها لن تتحقق.
رفضت راشيل أن ترضخ للأمر الواقع. حلّقت خارج السرب فاردةً جناحيها للريح والمطر، كي تخترق الحواجز.. والجدران.. والممانعات.. والرتابة وأوهام الانتظارات. راحت تغتسل بمياه الحب، وتذوب بنار العشق الذي أشعل روحها.. وأنعش جسدها، وأشعرها أنها كائنٌ إنساني عليه أن يروي رغباته وحاجاته، حتى تكتمل دورة الحياة.
لم يكن لدى راشيل أيّة مشكلة في اللقاء مع شباب قصر شمعايا من جيرانها الفلسطينيين. كانت تتبادل معهم أطراف الحديث اليومي، والنكت، والممازحات الودّية الخفيفة. تتعامل مع الجميع بود وتسامح وانفتاح. تداعب الأطفال، وتجامل الجارات الفلسطينيات، وتضحك ملء قلبها مع الشباب. تطرح السلام باحترام على الشيوخ… وبهذا السلوك فرضت حضورها الطاغي على جيرانها الفلسطينيين، على عكس شقيقاتها اللواتي حجبن أنفسهن داخل شرنقة خانقة من العزلة. نسجنها من خيوط الأوهام.. والشكوك.. والخوف.
لم تشعر راشيل بالحرَجْ، حينما بدأت بعض الهمسات بين النسوة في قصر شمعايا، حول علاقتها مع مروان. بل كثيراً ما كانت تقف معه أمام بيتها المحاذي لقصر شمعايا. تبادله الحديث والضحك الصافي الطليق…غير مبالية بنظرات شقيقاتها المتشككات…أو نظرات شباب الحارة الذين يعرفون أنها تذهب معه إلى السينما أحياناً، وإلى المسبح العائلي كلّ أسبوع، حيث يقضيا النهار هناك بمتعة واسترخاء.
فتَنَ مروان راشيل بوسامته. شابٌ أسمر، خفيف الظل، ومتحدّثٌ لبق، يدرس الطب، وهو الأكبر بين أشقائه، من عائلة مدينيه فلسطينية. كان عمره سنتين حينما هاجر أهله من فلسطين في العام 1948، ومثل كل الشباب من أبناء اللاجئين كان مهموماً بقضيته. يحاور وينفعل ويعيش صخب الأحداث… لكن على الرغم من شعوره الداخلي بأن علاقته مع راشيل بلا أفق، لأسباب لا تتعلّق به، أو بها، إلّا أنه لم يستطعْ كبحَ جماح مشاعره التي تدفقت نحوها، وواجه بسبب ذلك مشاكل كثيرة مع أهله، وتحمّل تعليقات ساخرة من أصدقائه، على الرغم من تفهّم بعضهم لطبيعة مشاعره نحوها.
شعر مروان بعد فترة أن حجم الضغوط عليه، هي أكبر من أن يجرؤ على خطوة الزواج من راشيل، فقرّر السفر إلى مصر، بذريعة إكمال دراساته العليا. شعرت راشيل بالإحباط والحزن الشديدْ، وكادت أن تقع في شرنقة عزلة شقيقاتها، إلّا أنها سرعان ما نهضت من كبوتها، واستعادت شيئاً من حيويتها بحكم طبيعتها، لكنها بعد مدة قصيرة. اختفت من الحارة، تحت ستار من السرّية الشديدة، التي لا يعرفُ أحدٌ خيوطها الخفية…
قال لي محمود، وهو شاب فلسطيني من قصر شمعايا هاجر إلى الولايات المتحدة، حيث استقرّ هناك، بعد أن فتح مطعماً صغيراً في نيويورك. يقدّم وجبات عربية „فتّات حمص وفول وفلافل…إلخ“، حينما التقيت به بعد سنوات طويلة، أثناء زيارته لأهله في سورية: في أحد المساءات كنت أتحدث مع أحد الزبائن بالإنكليزية، ولا أدري لماذا شعرتُ فجأةً بانخطاف نحو سيدة ستينية دخلت المطعم. لكأن جاذبية مغناطيسية شدتّني إليها. التفتُ نحوها، فحدّقت في وجهي، ثم عقدت الدهشةُ لسانينا!
قالت ببطء: محمو…….د ؟!
قلت: رااااشيل!
ثم تعانقنا…وأجهشنا بالبكاء.
جلسنا إلى طاولة صغيرة في زاوية المطعم، ورحنا نتبادل الحديث بحرارة لأكثر من ساعتين. كأن شلال حنين تفجّر في داخلينا، وراح يرنو لعبق المكان في قصر شمعايا.. وحارة اليهود الدمشقية. حدثتني راشيل عن أشواقها للحارة وأمسياتها. ذكرتني بمواقف وطرائف كثيرة غابت عن ذاكرتي، وحينما سألتها بمواربة عن مروان كي لا أجرح مشاعرها. نظرت إليّ بانكسار، وعلّقت بهمس حزين: مروان ترك جرحاً غائراً في قلبي لم يدمله الزمن، لكني سامحته، ولم أحقدْ عليه، لأني على يقين أن القضية أكبر مني ومنه. بقيت سنوات أعيش على أمل اللقاء به. حاولت أن أحصل على عنوانه في مصر دون جدوى، ومع الزمن لم يبق منه سوى طيف ذاكرة، يغيبُ أحياناً ويلحُّ بحضوره عليّ أحياناً أخرى، ليذكرّني ربما، بالجرح الغائر في صدري.
قال محمود بعد فترة صمت أضافت راشيل: منذ أن غادرت سورية على إثر انكسار علاقتي مع مروان. توجهت إلى الولايات المتحدة، واستقرّ بي المقام في „بروكلين“ ، حيث تقيم جالية كبيرة من اليهود السوريين. عُرض عليّ السفر إلى اسرائيل وقُدّمت لي مغريات كثيرة، لكني رفضت. عملتُ ممرضة في مركز للمسنين، وعلى الرغم من سهولة ورخاء العيش هنا، إلّا أنني أشعر أن حياتي باتت بلا طعم ولا رائحة. تمضي الأيام والشهور والسنوات هكذا… لا أدري كيف ولماذا لم أتزوج .. وأنجب، وحين أنظر إلى عزلة المسنين في المركز أدرك أن حياتي ستنتهي إلى هذا المآل: امرأة عجوز محطمة. تعيش حياةً باردة، بلا دفء أو أسرة ترعاها، أو تهتم لأمرها. حينئذ أتذكّر حياتنا هناك.. أتذكّر شقيقاتي، وأعرف أن حياتهن أيضاً بائسة.
أتساءل: ما الذي حلّ بنا.. ولماذا كلّ هذا الخراب ؟!




