كاترين دونوف لا تشبهني
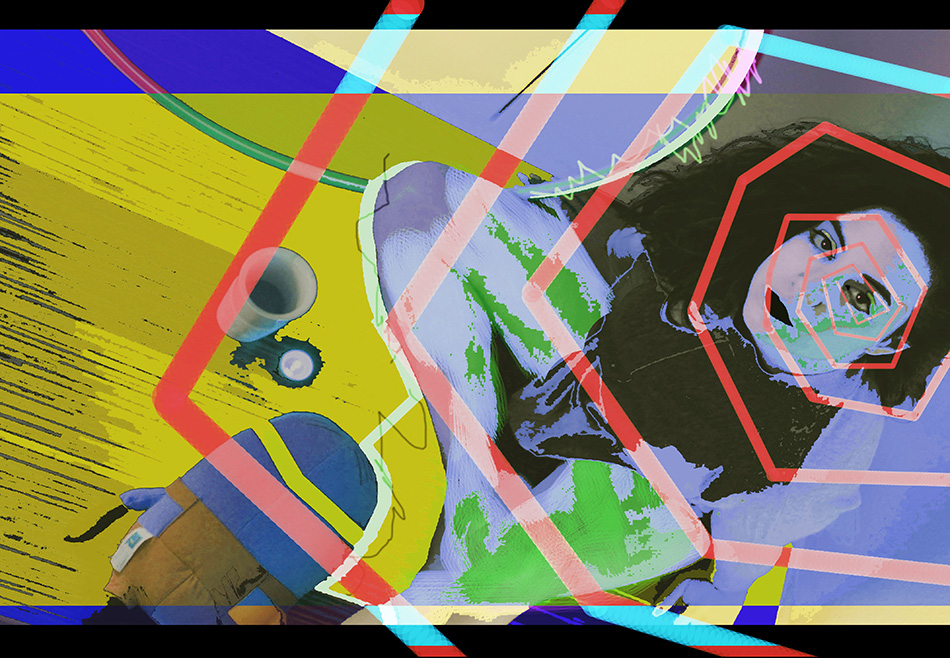
الموتى لا يبرعمون، ولا يصنعون „قمر الدين“*، لكنهم يملكون المزيد من الوقت الكثيف، الراكد، لتبرير حقيقة مثل:“كاترين دونوف لا تشبهني“، الياء هنا عائدة عليَّ أنا الميتة …
سحبوني إلى الخارج، في اليوم الذي كان سيزداد فيه طولي، أكثر من أي يوم آخر. يد ثقيلة انتزعتني من نومي، لم أميزها، الأيدي في بيتنا متطابقة إلى حد مدهش.
وضع أبي يده على فمي وأومأ بعينيه الجاحظتين ألا أنبس بحرف، ظهرت أمي من خلفه أشبه بشخصيات خيال الظل، تؤكد بإيماءات طريفة أنها موافقة على ما يجري.
تذكرتُ حكايات عمتي، وخمنتُ أن قدمي انزلقت ودخلت إحدى حكاياتها الغرائبية، وأنا أمشي في منامي.
في الأيام الأخيرة قبل دخولي الحكاية، استحوذ جسدي بكل تفاصيله على تفكيري، كنت أنمو كشجرة حور، أتطاول فوق مقعد الدراسة وأسابق أقراني بشكل ملفت، شعري الأشقر أيضاً استطال كالزنبق البلدي.
الركلة القوية التي دفعتني إلى الحظيرة، لم تخذلني كانت رهيبة بمستوى الحكاية التي هيأتها في مخيلتي.
بعد جلسة تحقيق في الحظيرة، امتدت حتى طلوع الفجر، أُخرجت مباشرة إلى عيادة الطبيبة النسائية، التي أفسدت خط التشويق في الحكاية بدم بارد، و بكلمات لم أفهمها في حينها:
ـ بلوغ مبكّر جداً….
ـ كنتِ صغيرة لا تحاسبين، الآن سيضع الله على كتفيك ملاكين، يسجلان كل شاردة وواردة.
قبل أن تنهي أمي كلامها ألقت على زنابقي الشقراء خرقةً، فَزِعَ جسدي من تلك السدادة على رأسي، وتراجع عن عزمه على الاستطالة، حدث ذلك في اليوم الذي كان فيه طولي سيزداد ليقترب من طول قامة كاترين دونوف.
عادت أمي إلى يومياتها في الفِلَاحَة، لم تخبرني كيف أسدّ ما بين فخذي لأمنع سريان الدم، فتناولت أول قماش وقعت يدي عليه، وكان جوارب برائحة الجبن الفاسد.
انتهت الحكاية بتركي مع ملاكين أبلهين، يجلسان طوال الوقت على كتفي (يفصفصان) بذور دوار الشمس، يدسان أنفيهما في أكثر المناطق حرجاً، ويرسلان تقارير كاذبة، لم يكن لها تأثير يُذكر في حياتي، إلا في ذلك اليوم، الذي تذوقت فيه حياة الطلَبة اللذيذة ونسيت الفِلَاحَة.
لطالما شعرت أنني فلّاحة، تملأ وقت فراغها بالمحاضرات. الحيوات المتدفقة في الكتب التي كانت تختبئ في قبو ذاكرتي، مع مادة حافظة اسمها رهاب الثقافة كانت بالنسبة لي، أقرب إلى الألعاب النارية التي تُطلق في مواسم الأفراح منها إلى الحياة العملية. أستحضر تلك الحيوات وقت المناظرات، والاستعراض البهي وكنت أُعد العُدّة للإجهاز بها على طلابي عندما يحالفني الحظ، وأحصل على وظيفة في التدريس.
الدعوة التي وجهتها لي مجموعة من زملائي في الجامعة للانضمام إلى ما أسموه“ النادي السينمائي“ أفسدت خطتي المستقبلية.
تمكنت من مشاهدة ثلاثة أفلام، أعياني منها فيلم „حسناء النهار“ للويس بونويل.
كان „لويس بونويل“ يقف في عمق الكوادر، كواحد من البصاصين، نعم „البصاصين“ أظن التعبير يتوافق مع نوايا „بونويل“ ومن هم على شاكلته، كان يختلس النظر إلى جسدي، ثم أخذ ينقّل نظراته بيني وبين كاترين دونوف في أكثر اللقطات حميمية. اتضح له، أن كاترين دونوف أوشكت أن تشبهني.
تشجع جسدي على الاستطالة مرة أخرى، غير عابئ بوصايا أمي المقدسة أشرت إلى بنطالي الذي قَصُرَ بسبب استطالة ساقيّ، وغمزت لـ بونويل:
ـ أكاد لا أصدق تأثير السينما على الفيزيولوجيا.
كاترين دونوف أوشكـ….. لو لم يرسل الملاكان تقريرهما الأمني إلى أبي، الذي سحبني من بين زملائي إلى سيارة سوزوكي، في الوقت الذي كان يشتكي عضو ما في جسدي وتتأهب الأعضاء الباقية بالتداعي له.
ـ هكذا تفسدين الشريط … لم تنته التجربة بعد. صرخ بونويل وهو يومئ لي أن أعود إلى مكاني.
لو لم يلمع الـ (C.D) كقطعة نقدية في ثلم الطين، لسارت الأمور بشكل طبيعي مثلما تسير كل يوم خميس، يوم مجيء بائع الزعتر الحلبي.
كان فلاحو الغوطة، يشقّون قنوات دقيقة بين شتلات الباذنجان، عندما تنادوا من بين جنائنهم، مشيرين إلى منعرج في البساتين البعيدة خلف أشجار الحور والصفصاف:
ـ إجا بياع الزعتر الحلبي .. إجا بياع الزعتر الحلبي
السروال الحلبي العريض وغطاء الرأس المزركش لم يغيرا شيئاً من ملامحه، عيناه الواسعة الجاحظة تشي بـ „البصّاص“ …
ـ يا إلهي كيف عرف بونويل مكاني؟. حدّثت نفسي وفكرت في الهروب.
بينما كان يقايض الجوز بالزعتر الحلبي وصابون الغار، حاول أن يدس في جيب جلبابي C.D“حسناء النهار“…لكنه وقع ولمع مثل قطعة نقدية في ثلم الطين، انتبه أحد أعمامي إلى الفضيحة، فأجهز على لويس بونويل بمَرَشَّة المبيد الحشري، وسط ذهول الفلاحين، الذين لم يتمادوا في أسئلتهم كثيراً، وقدّروا أن هناك جريمة شرف، ولا بد أن تعالج بمثل هذه الطريقة السريعة والبسيطة. رشات المبيد الحشري المتتالية، أوقعت بونويل وجعلته يتلوى كدودة، محتضراً بين الشتلات اليانعة.
ارتجفت الغوطة، وفاضت روحه الزاخرة بالشخصيات السينمائية، تبعها حاملو بيارق، جامعو آثار، صوفيون، مازوخيون، مدونو مآثر، قارعو طبول، ندابون، مداحون، شعراء، أنبياء، عاهرات، وآخرون ظهروا من دون ألوان، بالأسود والأبيض فقط.
امتد الحشد، غطى الغوطة واندفع باتجاه كفر سوسة والمزة وركن الدين.
كنت مأخوذة بفتنة غريبة. وسط ذلك الفيض، رق لها جسدي وبدأ يتسامق، كأنه سرخس خرافي. كاترين دونوف التي لامس كتفها كتفي أمسكت بخصري وضغطت عليه ضغطة خفيفة، أوشكت أن تشبهني بحق هذه المرة، لولا أن جياعاً سحبوني إلى سيارة دفع رباعي مع طن من باذنجان الغوطة، محاولين أن يصنعوا مكدوساً بالطريقة المعتادة: السلق ثم الرص حتى يخرج الماء.
أكملوا إعداد مؤنتهم في أٌقبية مظلمة. البشر الذين وقعوا خطأ وسط باذنجان الغوطة لم يخرج منهم ماء، وإنما دم، وهذا بديهي … لا أعرف لماذا أقوله لكم.
„في الهزيع الأخير من الليل“، أستعير هذا التزمين من شكسبير،لأنه يشي بالفعل الطارئ الذي خُطط له طويلا، لإغراق الضحية في دن النبيذ.
في القبو أُغرق الأشخاص في النبيذ الأحمر، سمعت أنيناً خفيضاً يخرج من بطن الأرض المكسوة بالأجساد المرتخية، والعيون المطفأة.
في الوقت الذي كانت كاترين دونوف تشير إلى رأسي الذي تحرر من الحجاب، وإلى تفاصيل جسدي العاري، وتصر على الشبه بيننا، سدت الدماء المختلطة الشقوق بين الأجساد، في متتالية بشرية فرشت أرضية القبو. وأنا أراني أنفصل عن لحمي ودمي، وأحظى برقم بدل دماء مهدورة، في اليوم الذي لم تشبهني فيه كاترين دونوف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*“قمر الدين“عصير المشمش“المحلى بالشكر والمجفف على شكل رقائق، وهو من الصناعات التقليدية في الغوطة .




